إجابة القرآن
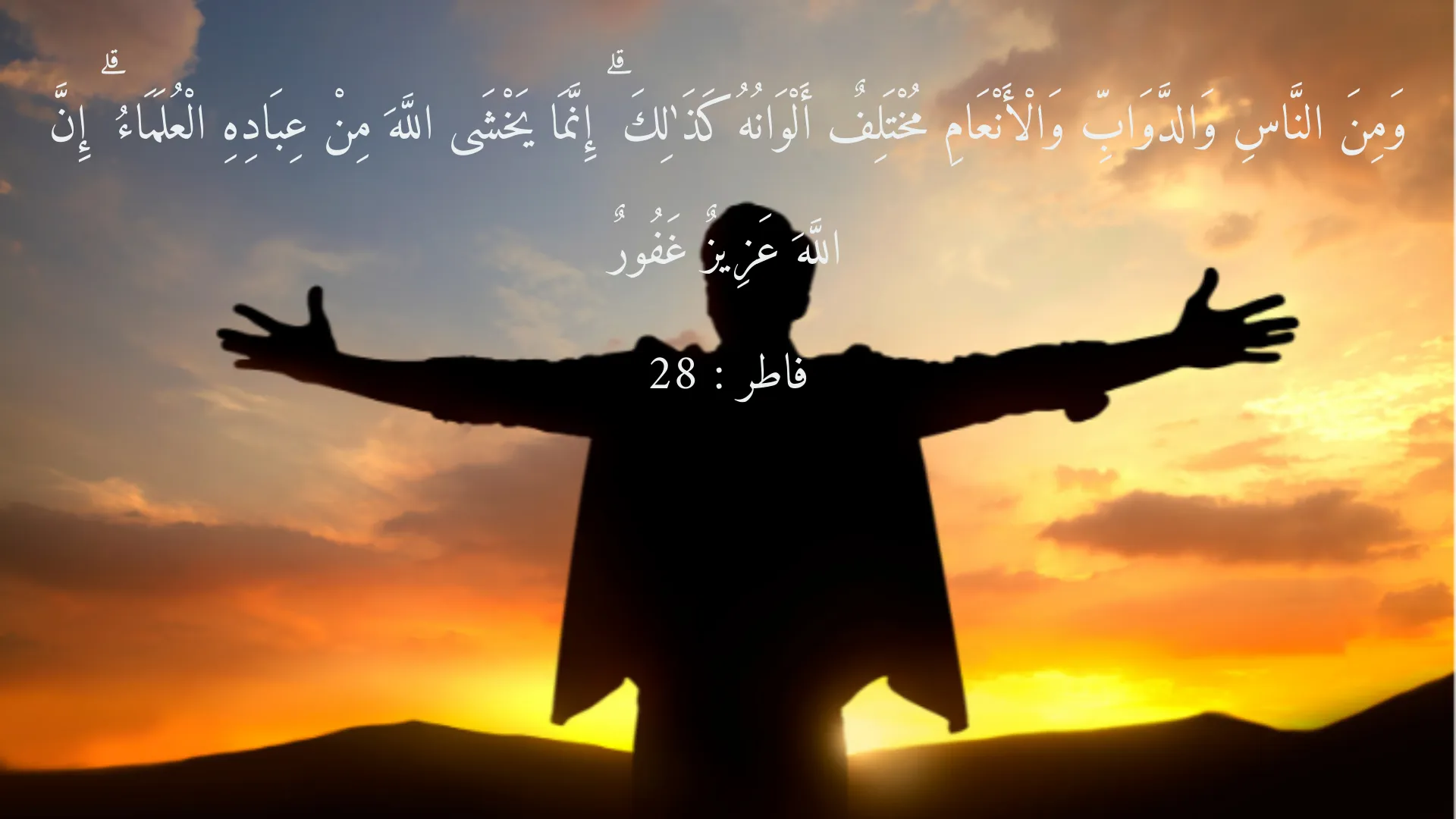
القرآن الكريم، بصفته كلام الله وهادياً للبشرية، يولي مكانة العلم والمعرفة، وبخاصة لحامليه الحقيقيين – أي العلماء الربانيين – قيمة وأهمية بالغة. يتجلى هذا التقدير والتكريم للعلماء الربانيين والحقيقيين بوضوح ودقة في آيات متعددة. ففي منظور القرآن، العالم الحقيقي هو من لا تؤدي معرفته إلى مجرد زيادة معلوماته، بل تحدث تأثيراً عميقاً في جوهره، وتدفعه نحو معرفة أعمق بالله وخشيته أكثر. هذه الخشية ليست من نوع الخوف من العذاب، بل هي من هيبة الله وعظمته، والتي تجعل قلب العارف يرتجف، وتدفعه إلى التواضع والتقوى. من أبرز الآيات في هذا السياق هي الآية 28 من سورة فاطر، التي تقول: «إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ». هذه الآية توضح بجلاء أن المعيار الحقيقي للعلم هو الوصول إلى مرحلة الخشية الإلهية. فالعالم الذي يصل إلى هذه المرحلة لا يقتصر علمه على النظريات، بل يتجلى هذا العلم في سلوكه وأفعاله، فيحوله إلى عبد مطيع، متواضع، ومحسن. هذه الخشية تدفعه لأن يكون حريصاً على أعماله وألا يتجاوز حدود الله، لأنه أدرك عظمة الله وقدرته اللامتناهية. هذه الصفة تميز العلماء الحقيقيين عن أولئك الذين جمعوا المعلومات فقط. فالقرآن يوضح أن العلم الحقيقي لا يعني حفظ الكلمات وتكرارها، بل يعني الفهم العميق للحقائق، والوصول إلى المعرفة الإلهية، والعمل بمقتضاها. العالم الحقيقي يحمل نور الله في قلبه، وهذا النور يضيء طريقه نحو الحقيقة. آية أخرى تشير إلى تقدير العلماء الحقيقيين هي الآية 11 من سورة المجادلة: «يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ». هذه الآية تبرز بوضوح فضل وأفضلية أهل العلم. فالقرآن يقيم صلة وثيقة بين الإيمان والعلم، ويشير إلى أن الإيمان الحقيقي يقترن بالعلم، والعلم الحقيقي يؤدي إلى الإيمان. أولئك الذين يتصفون بهاتين الفضيلتين لهم درجات رفيعة ومكانة عظيمة عند الله. هذا الرفع في الدرجات يشمل الاحترام والتأثير في الدنيا، ويؤدي إلى درجات الجنة والقرب الإلهي في الآخرة. إن رفع الدرجات يعني زيادة في البصيرة، والحكمة، والتأثير، والقدرة على فهم حقائق الوجود. فالعلماء الحقيقيون، من خلال هذه البصيرة، يمكنهم أن يكونوا قادة للمجتمع ويهدوا الناس من ظلمات الجهل والضلال إلى نور الهداية والمعرفة. بالإضافة إلى ذلك، يضع القرآن الكريم في الآية 18 من سورة آل عمران العلماء الحقيقيين في مكانة حيث شهادتهم تأتي إلى جانب شهادة الله والملائكة: «شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ». هذه الآية لا تعبر فقط عن عظمة العلم، بل تظهر أيضاً أن شهادة العلماء الحقيقيين تتمتع بمصداقية عالية لدرجة أنها توضع في صف واحد مع شهادة الله والملائكة. لكن هؤلاء «أولو العلم» هم الذين يكونون «قَائِمًا بِالْقِسْطِ» (مقيمين للعدل) أيضاً. هذا القيد المهم يوضح أن العلم بلا عمل وبلا مراعاة للعدل لا يمكن أن يصل إلى هذه المكانة السامية. العلم الحقيقي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالتقوى والأخلاق والسعي لإقامة العدل في المجتمع. فالعلماء الحقيقيون بعلمهم لا يصلون إلى إدراك التوحيد فحسب، بل يثبتون على العمل به، ويسعون بمساعدة الله لنشر العدل والحقيقة. علاوة على ذلك، في آيات متعددة، تم الإشارة إلى دور العلماء في هداية الناس والإجابة عن أسئلتهم. على سبيل المثال، في الآية 43 من سورة النحل (والآية 7 من سورة الأنبياء) ورد: «فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ». هذه الآية تؤكد ضرورة الرجوع إلى أهل العلم والتخصص في المسائل الدينية والمعارف الإلهية. هؤلاء «أهل الذكر» هم العلماء الربانيون الذين استمدوا علمهم من مصادر إلهية أصيلة وجمعوه بالتقوى والعمل. هذا التقدير للعلماء يعني تأييد دورهم كمرجعية دينية وفكرية للمجتمع. هذه الآيات تعلمنا أننا في المسائل المعقدة وغير المعروفة، لا ينبغي أن نكتفي بالتخمينات، بل يجب أن نرجع إلى ينابيع العلم والمعرفة الصافية، أي العلماء الحقيقيين. وهذا الرجوع ليس فقط لإيجاد إجابات للأسئلة، بل لاكتساب البصيرة والنمو الفكري والروحي. باختصار، يكرم القرآن الكريم العلماء الحقيقيين بصفتهم: 1. أولئك الذين يبلغون الخشية والخوف من الله بفضل علمهم. 2. أصحاب درجات رفيعة عند الله بسبب إيمانهم وعلمهم. 3. شهادتهم إلى جانب شهادة الله والملائكة، شرط أن يكونوا مقيمين للعدل. 4. المرجعية الفكرية والدينية للمجتمع، والتي يرجع إليها الناس لفهم الحقائق. هذا التقدير ليس مجرد ثناء جاف، بل هو تشجيع لجميع البشر للسير في طريق اكتساب العلم والمعرفة الحقيقية، والسعي لجعل علمهم نوراً يهدي إلى التقوى والعمل الصالح. يعلمنا القرآن أن نقدر هذه الينابيع المتدفقة من العلم والفضيلة ونستفيد من نور وجودهم. هؤلاء العلماء الربانيون هم ورثة الأنبياء، ويدلوننا على طريق النجاة. إن تقديرهم هو في الواقع تقدير للنور الذي وهبه الله للبشرية.
الآيات ذات الصلة
وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَٰلِكَ ۗ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ
فاطر : 28
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ ۖ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ
المجادلة : 11
شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ ۚ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
آل عمران : 18
قصة قصيرة
يُحكى أنه في قديم الزمان، سمع ملك عظيم الكثير عن رجل يدعي امتلاك علم وفضل واسعين. كان هذا الرجل يتحدث بفصاحة وبلاغة في المجالس، ويستشهد بالكتب والروايات من كل علم، معلناً نفسه الأعلم في عصره. وكان الملك في البداية مفتوناً ببلاغته ويوليه اهتماماً كبيراً. ومع ذلك، كان في نفس المدينة عالم آخر يعيش بهدوء وتواضع شديدين. كانت كلماته قليلة، لكن كل كلمة كانت تفيض بالحكمة العميقة والبصيرة. نادراً ما كان يتفاخر في المجالس، وكان أكثر انشغالاً بالعمل بعلمه وخدمة الناس.<br><br>في أحد الأيام، واجه الملك مشكلة تجاوز حلها قدرة وزرائه ومستشاريه. فأرسل أولاً إلى العالم المتباهي. فقدم هذا الأخير، بكل أبهة وخطاب منمق، إجابات معقدة وغير عملية زادت الملك حيرة. ثم، بناءً على نصيحة أحد المقربين منه، طلب الملك العالم المتواضع. وعندما وصلوا إليه، وجدوه يساعد المحتاجين. طلب الملك، مستغرباً، منه الإرشاد. فقدم العالم المتواضع، ببضع جمل قصيرة، ولكنها عميقة ومخلصة، حلاً بسيطاً وعملياً نابعاً من فهم عميق للحقائق والتعاطف مع الناس. شعر الملك بالسكينة عند سماع كلماته، وتم حل مشكلته بسهولة. في ذلك اليوم، أدرك الملك أن العلم الحقيقي لا يكمن في سعة الكلام والتظاهر، بل في عمق الفهم، والإخلاص، والتواضع، والخشية التي تنبع من المعرفة الإلهية، وتؤدي إلى العمل الصالح ونفع الخلق. وكما قال سعدي: «ليس العلم أن تقول ما تعلم، بل العلم أن تعمل بما تعلم»؛ أي أن العلم الحقيقي هو ما يؤدي إلى العمل وخشية الله، وليس مجرد التكرار والادعاء.