إجابة القرآن
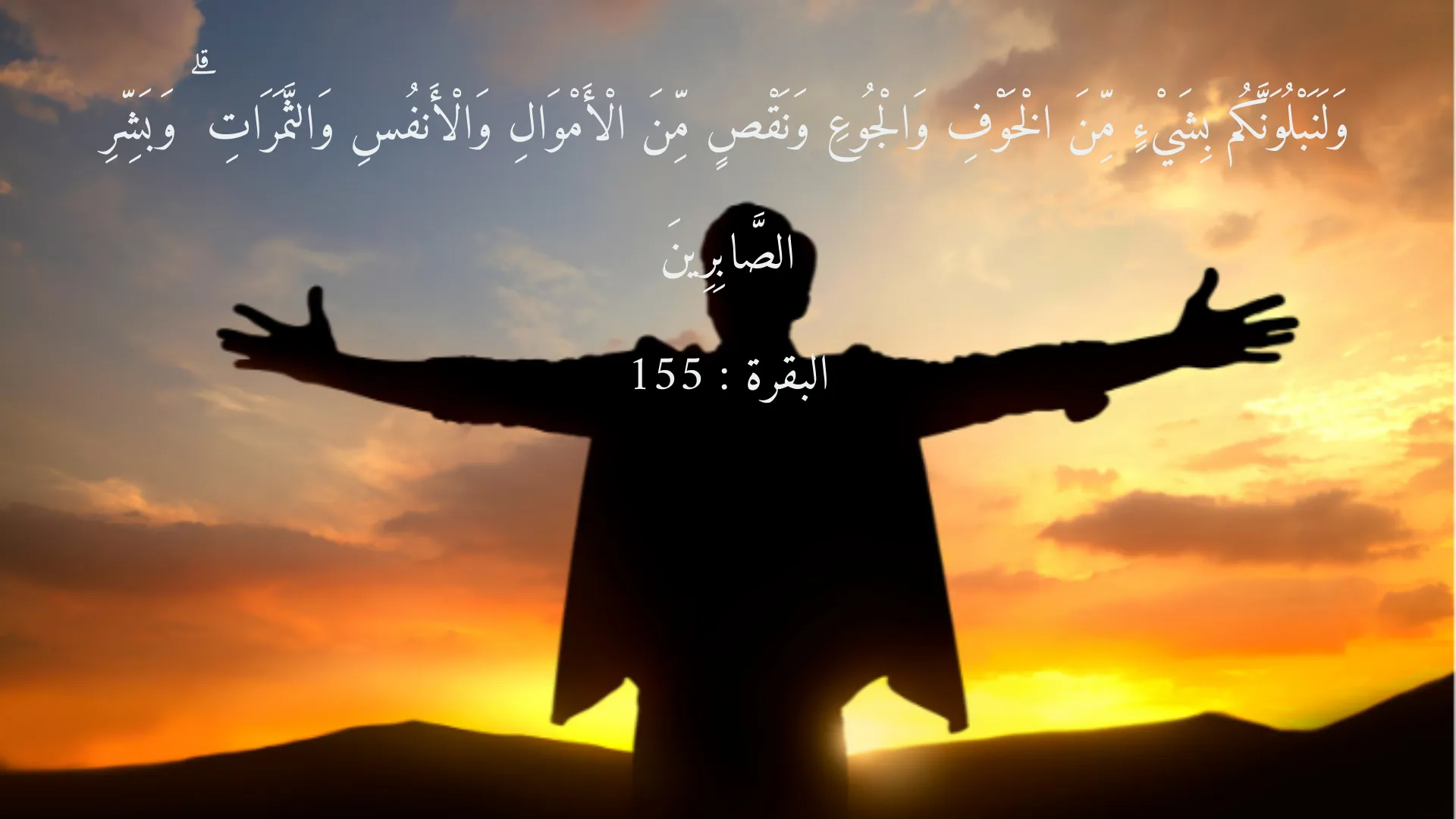
في منظور القرآن الكريم، ليست المعاناة والمشقات ظاهرة عبثية أو عشوائية؛ بل هي جزء لا يتجزأ من التصميم الإلهي الحكيم لحياة البشر. هذه الحقيقة المرة ولكن المثمرة بعمق، تُقدم في التعاليم الإلهية ليس فقط كمصيبة مجردة، بل كطريق نحو "السمو الروحي" و"النمو المعنوي". يعلمنا القرآن أن الدنيا دار ابتلاء وامتحان، ولا يُقبل ادعاء أحد بالإيمان دون المرور ببوتقة الصعوبات. فالمعاناة، سواء كانت في شكل خوف، أو جوع، أو نقص في الأموال والأنفس والثمرات، كلها أدوات في يد القدرة الإلهية المطلقة لتمتحن جوهر الوجود الإنساني، وتصقل إيمانه، وتوجهه إلى مراتب أسمى من القرب الإلهي. أحد المفاهيم المحورية في هذا الصدد هو مفهوم "الابتلاء" أو "الامتحان". فالله تعالى يقول صراحة في سورة البقرة، الآية 155: "وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ". هذه الآية ترسم صورة واقعية للحياة، حيث المشقات لا مفر منها. لكن النقطة الجوهرية تكمن في تكملة الآية التي تشير إلى "الصبر" و"البشارة". فالصبر ليس مجرد تحمل سلبي؛ بل هو مقاومة فعالة، مصحوبة بالتوكل والأمل في رحمة الله. هذا الصبر هو قوة داخلية تمكن الإنسان من الثبات أمام عواصف الحياة، وأن يتعلم منها دروسًا عميقة. فالذين يواجهون المعاناة بالصبر والرضا بقضاء الله، هم الذين "أُوْلَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ" (البقرة: 157). هذه البشارة تمثل ذروة السمو الروحي الذي ينبع من قلب المعاناة. ويوضح القرآن أيضًا في سورة العنكبوت، الآيتين 2 و3، هذه الحقيقة بأن الإيمان لا يكون بالقول وحده، بل يجب أن يثبت في العمل: "أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۖ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ". تُظهر هذه الآيات بوضوح أن المعاناة والابتلاء هي أدوات إلهية لتمييز الحق من الباطل، والصدق من الرياء. قد يدعي الإنسان الإيمان في أوقات الرخاء والراحة، ولكن في مواجهة التحديات والصعوبات فقط يتجلى عمق وثبات إيمانه. هذه العملية بحد ذاتها هي طريق نحو معرفة الذات وبناء الشخصية، مما يؤدي في النهاية إلى السمو الروحي. يتعلم الإنسان أين تكمن نقاط ضعفه وكيف يمكنه التغلب عليها بالاعتماد على قوة الله اللامتناهية. علاوة على ذلك، يمكن للمعاناة أن تعيد الإنسان إلى ربه وتوطد علاقته بخالقه. في لحظات الشدة، عندما تُسد جميع الطرق وتنقطع الأيادي المعينة، يعود الإنسان إلى فطرته الإلهية ويجد الملجأ الحقيقي الوحيد في الله. هذه العودة هي عودة عميقة وصادقة، تؤدي إلى التوبة والاستغفار والتوكل المطلق. هذه التجارب تحرر الإنسان من التعلقات الدنيوية المؤقتة وتقوده نحو الحقيقة المطلقة. كما يقول الله تعالى في سوره یونس، آیه ۱۲: «وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ ۚ كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ». ولكن المؤمن الحقيقي هو الذي يتذكر الله في الشدة والرخاء، وتقربه المعاناة من ربه، لا أن ينساه بعد زوال المشكلة. إن موضوع «الصبر» حيوي للغاية في القرآن لدرجة أن عدة آيات تشير إلى جزائه الذي لا يُحصى. في سورة الزمر، الآية 10، نقرأ: «قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ ۚ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ۗ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ ۗ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ». هذا «الأجر بغير حساب» يشير إلى العظمة واللاحدودية التي أعدها الله للصابرين. وهذا يعني أن تحمل المعاناة بالصبر والرضا، لا يؤدي فقط إلى تعويض الخسائر الدنيوية، بل يفتح بابًا لرحمات الله الواسعة في الدنيا والآخرة. هذا الجزاء يتجاوز تصورات البشر، ولا يمكن فهمه إلا بالاعتماد على فضل الله وكرمه. يمكن للمحن أن تدفعنا إلى التأمل وتكشف لنا الحكم الكامنة في القضاء الإلهي. ففي كثير من الأحيان، يغفل الإنسان في أوقات الرخاء عن عمق وجوده ويتعلق بظواهر الحياة. ولكن مع حدوث المعاناة، يُجبر على الغوص في أعماقه، وإعادة تقييم قيمه وأولوياته، وإدراك الحقائق الخفية للوجود. هذه المراجعة تغير نظرة الإنسان للحياة وتدفعه نحو النضج الفكري والروحي. المعاناة بمثابة مطهر يفصل الشوائب عن الروح ويقرب الإنسان من جوهره النقي. هذه العملية تؤدي في النهاية إلى «التقوى» و«البصيرة» وهما الركيزتان الأساسيتان للسمو الروحي في الإسلام. الخلاصة هي أن المعاناة والمشقة في القرآن تُنظر إليها كأداة تربوية ورافعة للروح. هذا لا يعني تمجيد المعاناة بحد ذاتها، بل تمجيد رد الفعل الذي يبديه الإنسان تجاهها: الصبر، التوكل، التوبة، التفكير، والعودة إلى الله. في الواقع، المعاناة أشبه بفرن الحداد الذي يصقل فولاذ وجود الإنسان ويعده للوصول إلى قمم المعرفة والعبودية. فالسمو الروحي ثمرة تنمو من شجرة المعاناة الصابرة والمتوكلة، وهذا من أعظم أسرار الخلق التي قدرها الله بحكمته اللامتناهية لعباده. هذا المنظور يمنح المؤمن الطمأنينة بأنه حتى في أصعب اللحظات، هناك هدف أسمى خلف الستار، وأن معاناته لن تذهب سدى.
الآيات ذات الصلة
وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ
البقرة : 155
أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ
العنكبوت : 2
وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۖ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ
العنكبوت : 3
قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ ۚ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ۗ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ ۗ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ
الزمر : 10
قصة قصيرة
حُكي أن ملكًا كان جالسًا في سفينة مع غلام. لم ير الغلام البحر قط، وبدأ يصرخ ويبكي من القلق والخوف. حاول الملك تهدئته، لكن دون جدوى، وقد أفسد عليه كل راحة السفر. كان في السفينة رجل حكيم. قال للملك: «إذا سمحت، يمكنني تهدئته.» قال الملك: «حسنًا جدًا.» فأمر الحكيم أن يلقى الغلام في البحر. جاهد الغلام عدة مرات ثم غرق. ثم أمسكوا بشعره وأعادوه إلى السفينة. الغلام، الذي نجا من موت محقق، هدأ وجلس في زاوية. استغرب الملك وسأل الحكيم: «ما الحكمة في هذا الفعل؟» أجاب الحكيم: «لم يذق الغرق قط، ولم يعرف قيمة سلامة السفينة. فمن لم يعرف قيمة العافية، فإما أن يتذوق طعم المعاناة أو يتعلم ممن عانوا.» هذه القصة الجميلة لسعدي تقدم درسًا عميقًا حول المعاناة والامتنان. حتى لم يجرب الغلام الغرق، لم يكن يقدر أمان وهدوء السفينة. في بعض الأحيان، تكون الشدة والصعوبة هي الأداة التي تفتح أعيننا على النعم والراحة الموجودة، وتقودنا إلى فهم أعمق للحياة والشكر. هذه التجربة، وإن كانت صعبة، ساعدته على الخروج من غفلته والوصول إلى سمو في فهمه وإدراكه.