إجابة القرآن
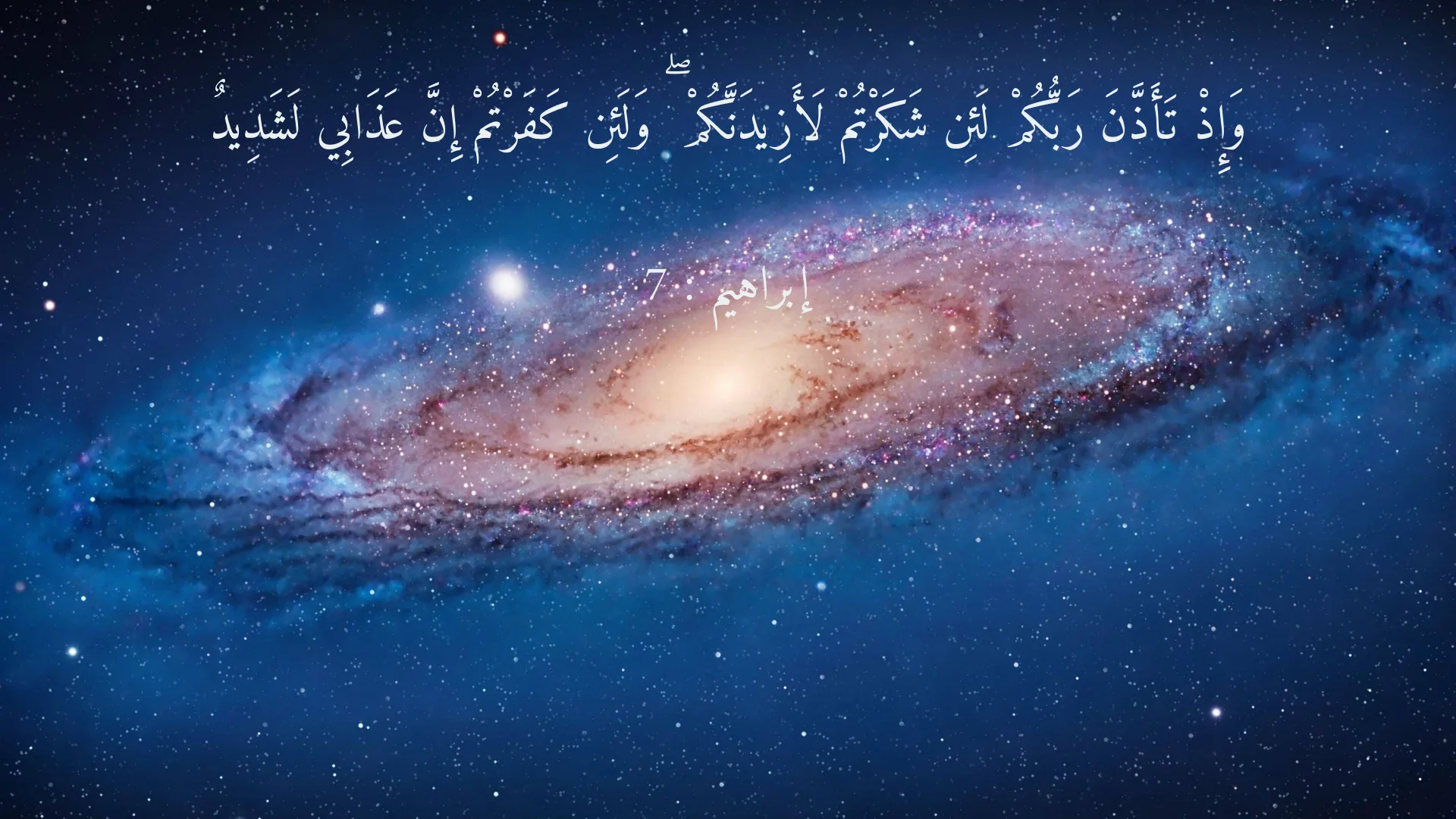
كيف لا أسيء استخدام رحمة الله؟ هذا السؤال عميق وحيوي للغاية، لأن علاقة الإنسان برحمة الله اللامتناهية يجب أن تبنى على الفهم والاحترام والمسؤولية، لا على وهم الأمان أو الاستغلال. يقدم القرآن الكريم، هذا الكتاب الهادي، حلولاً واضحة ومبادئ قوية لتحقيق هذا التوازن الدقيق، لضمان ألا يتخذ الإنسان رحمة الله ذريعة لذنوبه وتجاهله. في الحقيقة، إن سوء استخدام رحمة الله يعني أن الفرد يعتقد أنه يستطيع ارتكاب أي ذنب أو عصيان، آملاً أن يغفر الله له، دون أن يُحدث أي تغيير في سلوكه أو نيته. هذا الموقف لا يتعارض مع التعاليم القرآنية فحسب، بل يضعف إيمان الفرد تدريجياً ويحرفه عن الصراط المستقيم، وقد يؤدي إلى قسوة القلب، حيث يصبح الذنب أمراً عادياً، ويخلق الأمل الزائف بالمغفرة دون بذل جهد للتغيير حجاباً بينه وبين خالقه. فكرة أن يُستغل لطف الله كذريعة للتهرب من مسؤولية الأفعال هي في تناقض تام مع روح الشريعة وفلسفة خلق الإنسان. المبدأ الأول والأهم الذي يطرحه القرآن لمنع سوء استخدام رحمة الله هو "الشكر" مقابل "كفران النعمة". فالله سبحانه وتعالى يقول في سورة إبراهيم، الآية 7: «لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۖ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ» (لئن شكرتم لأزيدنكم، ولئن كفرتم إن عذابي لشديد). رحمة الله هي أعظم نعمة منه تعالى؛ تشمل فرصة الحياة، والهداية، والصحة، وكل ما يصيبنا من خير وبركة. وسوء استخدام هذه الرحمة هو نوع من الجحود وكفران النعمة. فالشخص الذي بدل أن يستخدم رحمة الله للنمو والتقرب إليه وأداء الأعمال الصالحة، يجعلها عذراً للإهمال والعصيان وارتكاب الذنوب، فهو في الواقع يتجاهل هذه النعمة ويتجه نحو العذاب. الشكر الحقيقي ليس مجرد قول باللسان، بل هو بالقلب والعمل؛ أي أن يظهر الإنسان من خلال أفعاله وسلوكه أنه يقدر هذه الموهبة الإلهية ويستخدمها في سبيل مرضاة الله. هذا يعني أن كل نفس، وكل فرصة، وكل يوم يمنحنا إياه الله، هو فرصة ثمينة للتقرب إليه أكثر، وليس منصة للمعصية. سوء استخدام الرحمة، بمثابة استخدام نعمة للإضرار بالنفس والآخرين، وهذا هو عين الجحود. المبدأ الثاني الأساسي هو "التوازن بين الخوف والرجاء". المؤمن الحقيقي لا ييأس من رحمة الله ولا يفقد الأمل في مغفرته، ولكنه أيضاً لا يشعر بالأمان التام من مكر الله. في سورة الأعراف، الآية 99، يقول الله تعالى: «أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ ۚ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ» (أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون). "مكر الله" هنا يعني تدبير الله وسنته الإلهية التي قد تظهر على شكل تأخير العقوبة الفورية، أو تأجيلها، أو حتى منح فرص إضافية للعودة، ليُجر العبد إلى الهلاك بنفسه. وسوء استخدام الرحمة هو تحديداً هذا الشعور الزائف بالأمان. فالفرد يعتقد أنه يستطيع ارتكاب أي ذنب، ولن يعاقبه الله فوراً أو سيغفر له دائماً، دون الحاجة إلى التوبة أو تغيير مساره. هذا الوهم يقود الإنسان إلى الهلاك والعاقبة غير المرغوبة. يجب على المؤمن دائماً أن يحافظ على توازن بين الأمل في مغفرة الله الواسعة (الرجاء) والخوف من عواقب ذنوبه وعدل الله المطلق (الخوف). هذا التوازن يضمن أنه من جهة لا ييأس من رحمة الله ولا يرى طريق العودة مسدوداً أبداً، ومن جهة أخرى لا يجرؤ أبداً على ارتكاب الذنوب، ويبقى دائماً متيقظاً لأعماله. وهذا الخوف ليس خوفاً نابعاً من اليأس والقنوط، بل خوفاً من عظمة وعدل الله، مما يؤدي إلى الابتعاد عن الذنب والسعي للتقوى. الاستراتيجية القرآنية الثالثة لمنع سوء استخدام الرحمة الإلهية هي "التوبة النصوح" و"المسؤولية الفردية". في سورة الزمر، الآية 53، نقرأ: «قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ» (قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم). هذه الآية، التي هي نبع أمل ودعوة للعودة، لا ينبغي تفسيرها كترخيص للاستمرار في الذنب. عبارة "أسرفوا على أنفسهم" تشير إلى أن هذه الدعوة إلى التوبة موجهة لمن ارتكبوا الذنوب وهم الآن نادمون على فعلتهم وينوون الإصلاح والتعويض. رحمة الله تشمل أولئك الذين بعد الذنب يندمون حقاً وينوون التوبة والابتعاد عن الذنب (توبة نصوح وعودة صادقة). سوء استخدام هذه الآية يحدث عندما يرتكب الفرد الذنب عمداً وبنية مسبقة، آملاً أن يكون مجرد قول "أستغفر الله" لاحقاً كافياً، دون أن يحدث أي تغيير حقيقي في سلوكه أو نيته، أو دون تعويض الحقوق التي انتهكها. هذا النوع من "التوبة" ليس حقيقياً، وهو في الواقع ذريعة للاستمرار في الذنب. المسؤولية تعني قبول حقيقة أن لكل فعل نتيجة، وأن رحمة الله هي لأولئك الذين يسعون ليكونوا على الطريق الصحيح، وفي حال زلت قدمهم، يعودون بصدق ويعوضون ما فاتهم. بشكل عام، عدم سوء استخدام الرحمة الإلهية يعني فهماً عميقاً لعظمة الله، وتقديراً لنعمه، والعيش في توازن بين الأمل والخوف. وهذا يتطلب الوعي الذاتي، والمراقبة المستمرة للأفعال، وتجنب الغرور والخداع الذاتي. من يجتهد باستمرار في أداء الأوامر الإلهية والابتعاد عن نواهيه، وفي حال الخطأ، يعود فوراً إلى الله بتوبة نصوح ويسعى للتعويض، فلن يسيء استخدام رحمة الله أبداً. الرحمة الإلهية ليست ذريعة لعدم المسؤولية والتكاسل، بل هي حافز للتقوى، والتقدم، وتحقيق الكمال الإنساني. هذا الفهم الصحيح للرحمة يمكّن الإنسان من السير في طريق مرضاة الله والابتعاد عن الغفلة والضياع. وهكذا، لا يقترب الإنسان من رحمة الله الواسعة فحسب، بل يحقق أيضاً السلام والسعادة الحقيقية في حياته. وهذا المنظور الصحيح يمنع رحمة الله من أن تبقى مجرد شعار، بل يحولها إلى قوة دافعة للأعمال الصالحة والابتعاد عن أي عصيان. ولنتذكر دائماً أن الله الرحمن الرحيم، ولكنه في الوقت نفسه شديد العقاب وعادل، وهاتان الصفتان لا تتعارضان أبداً؛ بل هما مظهران لحكمته وعلمه اللانهائي.
الآيات ذات الصلة
وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۖ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ
إبراهيم : 7
أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ ۚ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ
الأعراف : 99
قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ
الزمر : 53
قصة قصيرة
روي أن درويشاً قال لنفسه: «ليت ملكاً عادلاً يحكمنا، فنتحرر من عناء الفقر والجوع.» فقال له آخر من أهل المعرفة: «أيها الدرويش، إذا كنت أنت ملكاً عادلاً، نفع الناس منك؛ لا أن تسعى أنت للاستفادة من الملك. رحمة الله واسعة على جميع عباده، وهو غني عن خدمتنا، ولكن إذا لم يندم أحد على ذنوبه وتكاسل في الطاعة، فكيف يتوقع أن تشمله الرحمة الإلهية؟ الناس يخدمون ملوك الأرض لينالوا منهم الخلع، أما ملك السماء فيُخدم لينالوا السعادة الأبدية. ومن لم يقدر النعم وأساء استخدام رحمة الله، فكأنه يكسر سلماً يصل إلى السماء، ويهوي إلى الهاوية بدلاً من الصعود.»